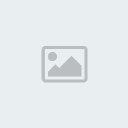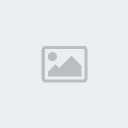تفسير سورة النجم
{بسم
الله الرحمن الرحيم}، تقدم الكلام عليها، {والنجم إذا هوى } النجم اسم جنس
يُراد به جميع النجوم، وقوله {إذا
هوى }: لها معنيان، المعنى الأول: إذا
غاب، والمعنى الثاني: إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو
مقسم
به {ما ضل صـاحبكم وما غوى } هذا جواب القسم،أي المقسم عليه {ما ضل
صـاحبكم } أي: ما جهل،{وما غوى } أي:
ما عاند، لأن مخالفة الحق إما أن
تكون عن جهل، وأما أن تكون عن غي، قال الله تعالى: { لا إكراه في الدين قد
تبين الرشد من
الغي } فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل،
وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم
ضد الجهل
وهو الضلال، {ما ضل صـاحبكم } ورشد ضد الغي {قد تبين الرشد من الغي} إذاً
النبي عليه الصلاة والسلام
كلامه حق وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد،
وقوله: {ما ضل صاحبكم } يخاطب قريشاً، جاء بهذا الوصف لفائدتين:
الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون صدقه، ويعرفون أمانته،فهو ليس
شخصاً غريباً عنهم حتى يقولوا
لا نؤمن به، لأننا لا نعرفه، بل هو صاحبهم
الذي نشأ فيهم،فكيف بالأمس يصفونه بالأمين، والآن يصفونه بالكاذب الخائن.
الثانية:
أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا
أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل رسول
الله» أو«ما ضل محمد»،بل قال: {ما ضل
صاحبكم }، فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به،
ومقتضى
الصحبة أن يكونوا مناصرين له {وما ينطق عن الهوى } أي: لا يتكلم
بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم
بشيء من أجل الهوى، ولكنه
ينطق بما أوحي إليه من القرآن، وما أوحي إليه من السنة، وما اجتهد به صلى
الله عليه وعلى آله
وسلم اجتهاداً يريد به المصلحة، فنطقه عليه الصلاة
والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن. الثاني: أن ينطق بالسنة
الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه. الثالث: أن ينطق باجتهاد
لا يريد به إلا المصلحة، أما نحن فننطق عما نريد به
المصلحة، وننطق عن
الهوى، وليس كل إنسان منا سالم من الهوى، يميل مع صاحبه، ويميل مع قريبه،
ويميل مع الغني، ويميل مع
الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن
أن يتكلم عن هوى،وإذا كان لايمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق
{إن هو إلا وحى يوحى } يعني ما القرآن {إلا وحى يوحى }، أي: وحي من الله -
عز وجل - والواسطة بين الله وبين الرسول
{علمه شديد القوى } يعني علم
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى، أي: ذو القوة الشديدة،
فهو من إضافة
الصفة إلى موصوفها، وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله
تعالى: {إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين}
فجبريل عليه
السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبداً أن يفرط بهذا الوحي الذي نقله
إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله
وسلم، كما قال تعالى: {نزل به الروح
الأَمين * على قلبك لتكون من المنذرين }. {ذو مرة فاستوى } المرة: الهيئة
الحسنة، فهو
ذو قوة، وذو جمال وحسن، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم على صورته التي خُلق عليها له ستمائة جناح قد سد
الأفق (1) ، فهو
الذي نزل بهذا القرآن، حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
قال تعالى: {نزل به الروح الأَمين
* على قلبك لتكون من المنذرين }. وقوله:
{فاستوى } أي فعلى، أو فكمل؛ لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر
مطلقاً
دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى: {ولما بلغ أشده
آتيناه حكمًا وعلمًا } أي: كمل، وتارة يقيد بعلى فيكون
معناه العلو، كما
في قوله تعالى: {وجعل لكم من الفلك والأَنعـام ما تركبون * لتستووا على
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا
استويتم عليه} فقال: {لتستووا على ظهوره }،
وقال: {إذا استويتم عليه} أي: علوتم عليه، ومنه قوله تعالى فيما وصف به
نفسه: {الرحمـن على العرش استوى } أي: علا عليه - عز وجل - العلو الخاص
بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع
المخلوقات، وتارة يتعدى بإلى،
ويقال: استوى إلى كذا، فيفسر بأنه القصد والانتهاء، ومنه قوله تعالى: {ثم
استوى إلى السماء
وهي دخان } وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل
قولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساواه، فقوله هنا: {فاستوى }
يحتمل أن
المعنى استوى على؛ لأن جبريل ينزل من السماء، فيلقي الوحي على النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصعد إلى
السماء، ويحتمل معناه كمل، ويكون
كامل القوة، والهيئة، وكامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات، {وهو }، أي
جبريل عليه
الصلاة والسلام{بالأُفق الأَعلى } أي: الأرفع، وهو أفق السماء،
{ثم دنا }أي من النبي صلى الله عليه وسلم ، {فتدلى } أي:
قرب من فوق،
{فكان } أي: جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم {قاب قوسين أو أدنى }،
وهذا مثل يضرب للقرب، {قاب
قوسين } يعني قريباً جداً، بل أدنى، فقوله {أو
أدنى } بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك، {فأوحى } أي: جبريل {إلى عبده مآ
أوحى } أي: إلى عبدالله، فالضمير في {أوحى } يعود على جبريل والضمير في
{عبده } يعود إلى الله عز وجل، أي: أوحى
جبريل إلى عبدالله ما أوحى، ولم
يبين ما أوحى به تعظيماً له، لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم
والتعظيم، ومنه قوله تعالى:
{فغشيهم من اليم ما غشيهم } أي: غشيهم شيء
عظيم، وهنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم
من
القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله - عز وجل -.
ثم
قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج: {ما كذب الفؤاد ما رأى } اعلم أيها
الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم
إسراءً ومعراجاً، فالإسـراء ذكره
الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في سورة النجم وكلاهما في ليلة
واحدة قبل الهجرة
بنحو ثلاث سنين، أو سنة ونصف، اختلف المؤرخون في هذا، ثم
إن الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول صلى الله عليه وسلم
وروحه، وليس
بروحه فقط، وأما قوله تعالى: {وما جعلنا الرءيا التى أريناك إلا فتنةً
للناس } فالمراد بها رؤية العين، لا رؤية
المنام، يقول الله تعالى في سياق
الآيات في المعراج: {ما كذب الفؤاد ما رأى } الفؤاد القلب، والمعنى أن ما
رآه النبي صلى الله
عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن
العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه
العين،
فمثلاً قد يرى الإنسان شبحاً بعينه فيظنه فلاناً ابن فلان، ولكن القلب
يأبى هذا، لأنه يعلم أن فلاناً ابن فلان لم يكن في
هذا المكان، فهنا العين
رأت، والقلب كذَّب، أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين
تكذبه، أما ما رآه النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه
رآه حقًّا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: {ما كذب الفؤاد ما رأى } بل تطابق
القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً
فما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو
صادق، ولكن المشركين
كذبوه، وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة
واحدة، ولهذا قال:
{أفتمارونه على ما يرى } والاستفهام هنا للإنكار
والتعجب، ومعنى تمارونه أي: تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بعلى
دون(في)، فلم يقل: (أفتمارونه في ما يرى) بل قال {على ما يرى }، إشارة إلى
أن الفعل ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه
تريدون أن تغلبوه على ما يرى،
أي: على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا
الشيء، وأنه عليه
الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن، لأن
الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، ولكن إذا عبر
بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده، فالمعنى على ما رأى من قبل،
ولكن عبر عمّا رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة، والحكمة البالغة، حيث
تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلابد أن يكون هناك
حكمة تظهر للمتأمل {ولقد رءاه نزلةً أخرى } رآه الفاعل محمد رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمدٌ جبريلَ {نزلةً
أخرى }، أي: مرة أخرى حين نزل، والمرة الأولى رأى الرسولُ عليه الصلاة
والسلام جبريلَ وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها، رآه
وله ستمائة جناح قد سد الأفق، كل الأفق الذي حول الرسول عليه الصلاة
والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم،وهذا يدل على عظمته،
ولهذا وصفه الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة
كما سبق في هذه السورة، والمرة الثانية: في السماء فوق السماء، فتارة رآه
من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء، ولهذا قال: {ولقد رءاه
نزلةً أخرى } أي مرة أخرى {عند سدرة المنتهى }، أي رآه عند السدرة،
والسدرة شجرة معروفة في الأرض، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست
كصفة السدرة التي في الدنيا، بل نبقها كالقلال، وأوراقها كآذان الفيلة (2)
، فهي شجرة عظيمة، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض،
وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل (3) ، فهي منتهى من الطرفين:
الطرف الأول: ما يصعد من الأرض إلى السماء، ينتهي عند هذه السدرة، وما
ينزل من الرب عز وجل ينتهي عند هذه السدرة،{عندها جنة المأوى}،أي: عند هذه
السدرة جنة المأوى، إذاً الجنة فوق السماء السابعة، لأنه إذا كانت السدرة
فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن تكون الجنة فوق السماء
السابعة، وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس، - جعلنا
الله من أهلها - فوقها عرش الرحمن جل وعلا، ولهذا قال تعالى: {كلا إن
كتـاب الأَبرار لفي عليين } وعليين مبالغة من العلو، يعني في أعلى الشيء،
{المأوى } يعني المصير، مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يأوون
إليها ويخلدون فيها، وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ بالله، وفي هذا
دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار،
ولا ثالث لهما، فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة، قال السفاريني -
رحمه الله - في عقيدته:
وكل إنسان وكل جِنةٍ في دار نارٍ أو نعيم جنة
ويستفاد
من قوله {المأوى } أن القبور ليست هي المأوى والمثوى، لأن القبور ممر
ومعبر، إذ إن وراء القبور بعث، ويذكر أن بعض الأعراب في البادية سمع
قارئاً يقرأ قول الله تعالى: {ألهـاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر} فقال
الأعرابي بفطرته وعربيته: «والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئاً»،
لأن الزائر يزور ويمشي، والقبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكثوا،
ثم يخرجون منها، قال الله تعالى: {ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون }
فالناس لابد أن يبعثوا، والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحياناً أن الرجل
حملوه إلى مثواه الأخير، يعني إلى المقبرة عبارة غير صحيحة، لأن القبور
ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه ينكر
البعث {إذ يغشى السدرة ما يغشى } السدرة هي سدرة المنتهى، لأنه تعالى قال:
{ولقد رءاه نزلةً أخرى * عند سدرة المنتهى}: {إذ يغشى السدرة } وأل في مثل
هذه العبارة تسمى عند النحويين (ال) للعهد الذكري كقوله تعالى: {كمآ
أرسلنآ إلى فرعون رسولاً * فعصى فرعون الرسول فأخذنـه أخذاً وبيلاً} {ما
يغشى }، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله
عزوجل بلحظة، كن فيكون، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه
غشيها
من الحسن والبهاء ما لايستطيع أحد أن يصفها (4) ، {ما زاغ البصر وما طغى }
البصر بصر النبي صلى الله عليه
وسلم ، يقول
العلماء: {زاغ } أي انحرف يميناً وشمالاً،{وما طغى } أي: تجاوز أمامه،
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على
كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم
يلتفت يميناً وشمالاً، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال
أدبه عليه الصلاة
والسلام، وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً
تجده ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل، وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً
في
هذه اللحظة، لابد أن ينظر ما الذي حدث، لكن لكمال أدب النبي صلى الله
عليه وسلم ورباطة جأشه صلوات الله وسلامه عليه
وتحمله ما لا يتحمله بشر
سواه صار في هذا الأدب العظيم، ولهذا قال تعالى عنه: {وإنك لعلى خلق عظيم}
.
ثم
قال - عز وجل -: {لقد رأى من آيـات ربه الكبرى } وأنت أخي المسلم القارىء
للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير
دائماً {ولقد رءاه }، {لقد خلقنا الإنسان
في كبد }، {ولقد خلقنا الإنسان من سلـلة من طين } والأمثلة كثيرة، هذه
الجملة يقول العلماء: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم
مقدر، والثاني: اللام. والثالث: قد، لأن المعنى: (والله لقد) فتكون
جملة مؤكدة بالقسم واللام، وقد، والقسم مقدر لكن دل عليه السياق، ورأى
يعني النبي صلى الله عليه وسلم {من
آيـات ربه الكبرى }، الآية هي العلامة
المخصصة لمدلولها التي لا يشركه فيها أحد، وإلا لم تكن
آية، فالآية لابد أن تكون
خاصة بمدلوها، فليس كل علامة آية، بل هي التي
تختص بمدلولها، فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله
كبير
عظيم، وقوله {الكبرى } قيل: إنها مفعول ثان لرأى، أي: لقد رأى من
آيات ربه الكبرى، وقيل: إن الكبرى صفة لآياته،
والمعنى أنه رأى من آيات
الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى،
وليس ما رآه أكبر شيء،
بل قد يكون هناك شيء أكبر لا نعلمه، والحاصل أن
الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في هذا المعراج من آيات الله الكبير ما لم
يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر، ونحن لو رأينا
سرادقاً عظيماً لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا،
وجعلنا نلتفت يميناً
وشمالاً، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل
كان على أكمل ما يكون الاتزان،
وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من
الحجر عند الكعبة - والحجر من الكعبة - أسري به من ذلك المكان إلى بيت
المقدس
مسيرة شهرين، في لحظة لأنه ركب البراق،
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره، وسريع جداً وصل إلى هناك
وصلى بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، والسماء بعيدة جداً، ثم من سماء
إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسأل جبريل: من معك؟
فيقول: محمد، فيسألونه هل
أرسله إلى الناس؟ فيقول: نعم، ثم يسلم على بعض من في السموات من أنبياء،
ثم تفرض عليه
الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو ثابت الجأش
عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء حقيقي هو بنفسه عليه
الصلاة والسلام صعد،
ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في
عقلها، وإنكار ما لا يمكن
في العقل ليس خاصًّا بكفار قريش حتى فيمن ينتسب
إلى هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه، لأنه على زعمهم
لا يمكن في العقل، فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان مناماً لم تنكره
قريش، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر
حسي حقيقي أسري بالرسول
عليه الصلاة والسلام بجسده وعُرج به في ليلة واحدة، وحصلت كل هذه الأمور
ثم عاد إلى
الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام.{لقد رأى من
ءايات ربه الكبرى }، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله - عز
وجل - منها
الكبير ومنها ما دون ذلك، ولا نقول: منها الصغير. لأن الكبرى اسم تفضيل.
وغلط من قال من المفسرين
المتأخرين: إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل،
لأن آيات الله - عز وجل - إما كبيرة، وإما كبرى عظمى، فالمعراج
الذي حصل
لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة.






 ألحق لكل طفل مجموعة عالية الجودة من الخلفيات للشخصيات الكرتونية المشهورة
ألحق لكل طفل مجموعة عالية الجودة من الخلفيات للشخصيات الكرتونية المشهورة
 احترف برنامج الموفى ميكر
احترف برنامج الموفى ميكر إلى .......... حبيبى
إلى .......... حبيبى إلى كل من تريد التخلص من زوجها
إلى كل من تريد التخلص من زوجها قم بإلصاق وجهك مع أي شخص في العالم الآن مع face on body
قم بإلصاق وجهك مع أي شخص في العالم الآن مع face on body نشيد تعليم الأرقام مصور بطريقة تعليمية جذابة
نشيد تعليم الأرقام مصور بطريقة تعليمية جذابة
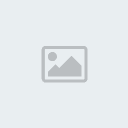
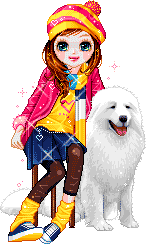
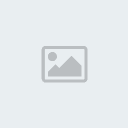


 من طرف
من طرف